هل آن للأمة أن تسترد مدارسها؟!
في ذروة انشغال مجموع الأمة بالمؤامرات الداخلية والخارجية المختلفة، والمتربصة
بالقطاع التربوي خاصة، غفلت النخب عن الالتفات إلى الواقع التربوي للمنظومة
التربوية، ما جعل التراكمات السلبية المحيطة والمكونة للمجال التربوي تصل حداً يجعل
السيطرة عليها أمراً عسيراً، ولأن الحديث في هذا الموضوع يحتاج إلى دراسات طويلة
فإننا نكتفي بالإشارة والتنبيه إلى أحد محاوره المهمة الوثيق الصلة بالشأن التربوي،
والمتعلق بـ«دور المدرسة في ظل التغيرات الاجتماعية الراهنة»، التي قلبت المفاهيم
والقيم، وأفرزت واقعاً جديداً، سببه الأول: اكتساح العولمة لكل مجالات الحياة، بما
فيها المجال التربوي - خاصة الأسرة والمدرسة - وسببه الثاني: عدم استعداد الأمة
لمواجهة العولمة، هذا التحول الاجتماعي الهائل والمنقلب، لم يعد من الممكن مواجهته
بقرارات وأفكار ترقيعية، نظراً لتغوله واستفحاله، ونجاحه في فصل الأسرة عن دورها
التوعوي التربوي، وتمييع دور المحاضن العلمية والتربوية الاجتماعية. الأمر الذي
يضعنا أمام هذا السؤال المحوري: هل من الصواب أن تستمر المراهنة على الأسرة بعد هذه
التحولات الخطيرة في بنية الأسرة المجتمعة؟ هل يمكن أن تُخرِّج الأسرة في وضعها
الحالي جيل البناء والشهود الحضاري؟
الأسرة وزلزال العولمة:
لقد كان الرهان على الأسرة في تربية النشء الأساس والأصل، باعتبارها الحاضنة الأولى
في المجتمع، حيث ظل الوعي الجمعي يرى أن تنشئة الطفل التنشئة الكاملة من مهماتها
الكبرى، وفي الوقت نفسه كان ينظر إلى دور المدرسة على أنه دور مكمل للخلية الأساس،
إلا أن زلزال العولمة الذي ضرب أسس الأسرة المسلمة أصابها في مقتل، ما جعلها تحيد
عن دورها الريادي في مسيرة البناء، فالعولمة جعلت الولي يعيش نمط حياة شاقاً وصعباً
لا يمكنه من متابعة وتوجيه فلذات أكباده، وجعلت الأسرة أسيرةً لتبعات الراتب
الزهيد، ما جعل همها الأول توفير المال من أجل العيش، وشتان بين أن تعيش وبين أن
تحيا، كما أن العولمة جعلت المنزل الأسري أشبه بأرخبيل من الجزر المنعزلة، حيث حدثت
عزلة شعورية خطيرة بين أفراد البيت الواحد، تكاد تقضي على اللحمة والتضامن الأسري،
كما أدت إلى ضياع الأدوار الواضحة في الأسرة، التي يفترض أن تكون موزعة بشكل فطري
ومنطقي، بعد ضعف القيم الرابطة بين مختلف الأفراد، وفقد القرار الأسري أهميته بين
الأفراد.
والسؤال المحوري بعد هذا العرض الذي جاء على وصف واقع تربية وتنشئة النشء هو: علام
نراهن اليوم في التربية؟ على الأسرة أم على المدرسة؟
مستقبلنا.. على من نراهن في بنائه؟
إن المراهنة على الأسرة في تربية النشء التربية الحقة والسليمة، لم يعد خياراً
يستحق الاعتماد عليه في تخريج جيل سليم، بسبب الأسباب التي تم ذكرها سابقاً، وبسبب
تراجع الدور الأسري الذي يُفقد يوماً بعد يوم، بفعل التأثير السلبي للمنظومات
الاقتصادية والسياسية المتصادمة مع هوية الأسرة المسلمة، والتي لا تسمح لها بلعب
دورها المحوري في المجتمع، ولضعف إمكانياتها المادية، لذلك فإن الرهان الحقيقي في
تربية الأجيال التربية الصالحة والمتكاملة يقع على المؤسسات الرسمية للتعليم
والتربية، لأسباب كثيرة، أهمها:
- وجود طاقم متخصص بالتربية والتعليم ضمن قطاع التربية، يساعد على أداء هذه المهمة،
خاصة مع بقاء الطفل سنوات طويلة ضمن هذه الهياكل التربوية، حيث يعيش الطفل أغلب
سنواته (من سن السادسة إلى سن التخرج من الثانوية) ضمن الأسرة المدرسية بمختلف
أطيافها، ما يتيح إمكانية متابعة مساره، والتأثير فيه.
- وجود هياكل قائمة ابتداء من الإدارة، إلى قاعات الدرس، إلى المساحات التي يمكن
استغلالها في مختلف المجالات ذات الصلة بتربية النشء.
- إمكانية التحكم في المحيط المدرسي من خلال الآليات والإجراءات المعتمدة إدارياً
وتربوياً.
الوسائل الكفيلة بجعل المدرسة بيئة مثالية لتخريج أجيال صالحة نافعة:
المصليات
المدرسية:
إن جولة واحدة داخل الهياكل التربوية في الوطن العربي تكشف حجم الانفصام الكبير
الذي بات القطاع التربوي يعانيه في هذا الجانب، جراء سياسات التغريب والعولمة، فما
عدا بعض المدارس في الدول الخليجية التي تهتم بهذا الجانب، الذي يراعي الجانب
التعبدي المفطور عليه الإنسان
-
يذكر أرنولد توينبي أن كل الاستكشافات الأثرية التي تمت كشفت عن وجود معابد بها، ما
يفيد بأن الإنسان متدين بفطرته
-
فإن أغلب الدول العربية لا تعطيه أهمية تذكر، بل إن بعضها لا يريد ذلك، خاصة أنه
يرتبط في أذهان بعض المسؤولين بفرضية غريبة عن تاريخ الأمة، وهي اعتبار التعبد
والالتزام طريقاً للتطرف، وهو ما يجب تجاوزه، فالإسلام في جل الدساتير العربية هو
دين الدولة، وبالتالي فإن المطالبة بإيجاد مصليات في مختلف الهياكل التربوية أمر
مشروع ومعقول، ولهذا فوائد كبيرة، فالتربية الإسلامية التي يتعلمها الأطفال في
المدارس ستغدو أكثر فاعلية إذا تم ربطها بجانب تطبيقي..
ثم لماذا الخوف وهذه المصليات ستكون تحت إشراف الدولة وإدارة حاضرة، ولو استغلت كما
يجب فإن مخرجات ذلك ستكون كبيرة، أقلها تخريج جيل صالح.
وتزداد أهمية إيجاد هذه المصليات إذا عرفنا أن أغلب القطاعات التربوية تعتمد على
دوام شبه يومي للتلاميذ والطلاب، فلا يعقل أن يقضي الطفل
13
سنة من عمره بعيداً عن الصلاة، التي تعد أحد الجوانب الروحية في حياة الطفل، ومعلوم
أن النظريات التربوية الغربية تؤكد على هذا الجانب، فـ«هرم ماسلو» يؤكد على أن
الإيمان أحد الجوانب التي تنبني عليها شخصية الطفل.
إن الصلاة من العظائم، وتعويد الطفل عليها من الصغر إنما يفيد في تعويده على
العظائم، ولذلك فإن المراهنة على المدرسة في تعويد النشء على الصلاة، وربط الأخلاق
الاجتماعية داخل المدرسة بها أمر ضروري وحاسم في الإقلاع الحضاري للمجتمعات المسلمة.
المكتبة:
لطالما كانت المكتبات المصل الذي يغذي المجتمع بنور المعرفة، وضياء الثقافة، إذ
يعبر وجودها في حياة المجتمع عن رقيه، كما يدل غيابها عن انحطاطه ثقافياً، فإيجادها
في حياة التلاميذ ورعايتها أمر واجب، باعتبارها من مصادر التعلم، بل إن رؤيتهم
للاهتمام الذي تحظى به المكتبة يعرفهم على قيمة الكتاب في حياة الأمم، كما أن
وجودها فرصة حقيقية للأساتذة والمعلمين للاحتكاك بتلاميذهم، وتعويدهم على البحث،
وهو الأمر الذي سيحقق في المستقبل نتائج باهرة، فالطفل الذي يتعود على صداقة
الكتاب، ويرسخ في ذهنه أهمية المراجع والتوثيق، سيكون لبنة قوية وسليمة في مستقبل
البحث العلمي الذي يعد ركيزة من ركائز النهوض بالأمة، كما أن الهدوء الذي تكون عليه
المكتبة عادة، والانضباط الكبير الذي يسودها، يساعد الطفل على تنمية مهارات التعامل
مع مرافق المجتمع استعمالاً وحفظاً.
البستنة:
عنصر البستنة من العناصر الغائبة بقوة عن المدرسة، وعليه فإن مشاريع بناء المدارس
مستقبلاً يجب أن تأخذ بعين الاعتبار إيجاد محيط صالح لممارسة البستنة، بدل الاكتفاء
بدراسة الوسط البيئي في الكتب، وبطريقة نظرية جافة، لا يمكن للأطفال استيعاب الكثير
من معانيها، بل إن البستنة تساعد في إيجاد جيل يملك تصوراً صحيحاً عن الأرض التي
يعيش فيها، ويعي دوره في الحفاظ عليها، من خلال الاستثمار الحسن فيها، حتى يكون
صديقاً للبيئة التي وهبه الله إياها، لا عدواً مدمراً لها، فالطفل الذي يعرف أهمية
ما يحيط به من طبيعة، سيكون عنصر بناء فعال، لا أداة طمس وإفساد للطبيعة التي سخرها
الله للبشر.
النوادي
الثقافية والورش الفنية:
إن إنشاء مرافق تتبنى تنمية مهارات الطفل الأدبية والفنية، أمر ضروري لا كمالي، فهي
تساعد الطفل على إظهار مواهب كثيرة مثل:
كتابة القصص والأشعار، وممارسة الرسم، والمسرح، والإنشاد، وإنشاء مجالات متنوعة، ما
يجعله قادراً على تنمية مهارات شخصيته، واستغلال أوقات الفراغ في شبابه، أو بعد
تقاعده، لأن الملحوظ أن الطفل العربي لا يحسن استغلال عطلته، وأن الرجل العربي إذا
تقاعد لم يجد أمامه سوى المقاهي وسيلة لقضاء فراغه، لأن الثقافة الغالبة على الطبقة
المتوسطة
-
التي تشكل أكبر طبقة داخل المجتمع العربي
-
لا تبالي كثيراً بمسألة تنمية الطفل لمهاراته، فهي تركز على أن ينجح ليعمل ويكون له
دخل ثابت، ولا تركز على أن يستمتع بحياته.
المرافق
الرياضية:
بسبب غياب المرافق الرياضية في حياة الطفل في العالم العربي، بات من الواجب التفكير
في إنشاء هياكل رياضية متنوعة ملحقة بالمدارس، ولهذا العنصر فوائد جمة منها:
تكوين أجيال سليمة صحياً وعقلياً، لا تحمل كثير ضغوطٍ، فممارسة الرياضة تعمل على
تفريغ الكثير من الشحنات السلبية في الموضع الصحيح، وتخرج جيلاً قوياً، يتبنى السلم
كحالة عامة، ويفهم أن القوة ليست في ظلم الآخرين، أو تبني العنف ضدهم، وبالمقابل
يفهم أن الاستعداد البدني مهم لمواجهة الأخطار المحدقة به في الحياة للدفاع عن دينه
ونفسه وأرضه وعرضه، ومن نتائج هذا المشروع أيضاً تخريج أجيال هادئة، بأعصاب باردة
قوية، تتحكم في ردات فعلها وفق مسارات صحيحة راشدة.
ماذا نجني من إستراتيجية الرهان على المدرسة في بناء الأجيال؟
خلاصة القول أن الرضا بالنظرة التقليدية التي كانت ترى المدرسة عبارة عن جدران من
الإسمنت، يسجن فيها الطفل لساعات معينة يومياً، يخضع لعملية تلقين غير راشدة ولا
واعية، ويخرج يومياً منها وهو يعيش حيرة وصراعاً ذاتياً محموماً، لأن ما يتلقاه في
المدرسة غائب غالباً عن محيطه ومجتمعه الصغير، لم تعد نظرة صالحة لهذه المرحلة،
فالمدرسة التي لا تنمي حاجيات الطفل، وتساهم في بلورة شخصية سليمة لا تعد مدرسة
مثالية، فالمدارس النموذجية بحق هي التي توفر للأطفال فرصة تحقيق رغباتهم
الفيزيولوجية والنفسية الفطرية، وتعزز فرص تقدير الذات وتحقيقها، وتسهم بشكل فعال
في تجنيب الطفل كل ما يعوق إشباع هذه الحاجات، ثم مرافقته في التنشئة الشاملة
النافعة، التي تجعله فرداً صالحاً اجتماعياً، ومُنتجاً لعناصر الحضارة، ومتعاوناً
مع غيره، لأن أهم الوسائل التي ستكون حاضرة في هذه المدارس هي «العمل الجماعي أو
العمل كفريق متكامل»، ما يسهل في المستقبل إيجاد مجتمع مؤسساتي صالح، ينطلق أساساً
من مبدأ العمل الجماعي الذي يحض عليه الإسلام.
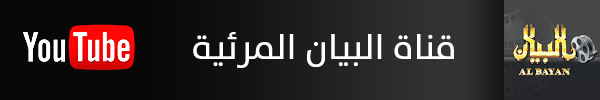
:: مجلة البيان العدد 350 شــوال 1437هـ، يـولـيـو 2016م.