( على خوف من فرعون )
مدخل:
أفاض القرآن الكريم في الحديث عن قصة موسى عليه السلام مع فرعون مصر لما فيها من
الدروس الوافرة والعظات البالغة، التي لا ينبغي إهمالها ولا الحيدة عنها.
وفي سورة يونس الكريمة تحدثت الآيات عن مرحلة حساسة في عمر الدعوة، وهي مرحلة
الاستضعاف والخوف اللذين لحقا بالقلة المؤمنة من الشباب الذين لم يؤمن غيرهم، سواء
كان هؤلاء الشباب من قوم فرعون[1]
أو من بني إسرائيل[2]
على خلافٍ بين المفسرين، وذلك بعد اللقاء الكبير بين فرعون وسحرته من جانب، وموسى
عليه السلام من جانب، والذي انهزم فيه فرعون وسحرته، قال الله تعالى:
{وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ 79 فَلَمَّا جَاءَ
السَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُّوسَى أَلْقُوا مَا أَنتُم مُّلْقُونَ 80 فَلَمَّا
أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرُ إنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إنَّ
اللَّهَ لا يُصْلِحُ عَمَلَ الْـمُفْسِدِينَ 81 وَيُحِقُّ اللَّهُ الْـحَقَّ
بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْـمُجْرِمُونَ 82 فَمَا آمَنَ لِـمُوسَى إلَّا
ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَن
يَفْتِنَهُمْ وَإنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الأَرْضِ وَإنَّهُ لَـمِنَ
الْـمُسْرِفِينَ 83}
[يونس: 79٩٧ - 83]،
قال ابن عاشور رحمه الله: «وفي هذا زيادة ثناء على قوة إيمانهم إذ آمنوا في حال
خوفهم من الملك مع قدرته على أذاهم، ومن ملئهم، أي قومهم، وهو خوف شديد، لأن آثاره
تطرق المرء في جميع أحواله حتى في خلوته وخويصته لشدة ملابسة قومه إياه في جميع
تقلباته بحيث لا يجد مفراً منهم»[3].
إجراءات الشدائد والخطوب:
مما جاء القرآن به هدايةً للمؤمنين به توجيههم في زمن الخوف والاستضعاف، وتنبيههم
إلى إجراءات الشدائد والخطوب.
من ذلك ما ورد في سورة يونس الكريمة المكية التي لامست الواقع الدعوي في مكة وعالجت
الظروف، فلكل مرحلة دعوية إجراءاتها، ولكل حدثٍ واجباته، وعلى أهل الدعوة أن يكونوا
قادرين على فهم واقعهم وتشخيصه بموضوعية، ثم عليهم أن يهتدوا بالتوجيهات الربانية
المطابقة لهذا الواقع أو المشابهة له.
قال الله تعالى في سياق مرحلة الاستضعاف والخوف في دعوة موسى عليه السلام:
{وَقَالَ
مُوسَى يَا قَوْمِ إن كُنتُمْ آمَنتُم
بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إن كُنتُم
مُّسْلِمِينَ
84
فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا
لا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِـمِينَ
85وَنَجِّنَا
بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ
86
وَأَوْحَيْنَا إلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن
تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا
وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا
الصَّلاةَ وَبَشِّرِ الْـمُؤْمِنِينَ
87
وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إنَّكَ آتَيْتَ
فِرْعَوْنَ وَمَلأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي
الْـحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَن
سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ
وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلا يُؤْمِنُوا
حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الأَلِيمَ
88
قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا
وَلا تَتَّبِعَانِّ سَبِيلَ الَّذِينَ لا
يَعْلَمُونَ
89}
[يونس:
84
-
89].
تتلخص هذه التوجيهات الكريمة الرحيمة في عنصرين مهمين للغاية في تربية أهل الدعوة،
ودفع غربتهم من خلالهما، وهما عنصر التربية الإيمانية وعنصر التربية الحركية..
على البسط الآتي:
التربية الإيمانية:
اعتنت الآيات الكريمة بالتربية الروحية في زمن الاستضعاف، لأن «العقيدة هي السلاح
الأول في المعركة، وأن الأداة الحربية في يد الجندي الخائر العقيدة لا تساوي شيئاً
كثيراً في ساعة الشدَّة»[4].
وتكون هذه التربية
-
بحسب الآيات
-
بما يلي:
أولاً:
العناية بعبادات القلب، وتعلقه بالله تعالى، وتوجهه إليه، وتفويض الأمر إليه،
والتوكل على الله، والاعتماد عليه بالكلية، واليقين بوعده، والثقة بنصره، فإن
«التوكل على الله دلالة الإيمان ومقتضاه، وعنصر القوة الذي يضاف إلى رصيد القلة
الضعيفة أمام الجبروت الطاغي فإذا هي أقوى وأثبت»[5].
قال ابن جرير رحمه الله:
«فبه ثقوا، ولأمره فسلموا، فإنه لن يخذل وليَّه ويُسْلِم من توكل عليه»[6]،
وقال القرطبي رحمه الله:
«بيَّن أنَّ كمال الإيمان بتفويض الأمر إلى الله»[7].
إن أهل الدعوة بحاجة إلى جرعة إيمانية عالية تقوي توكلهم على الله تعالى، وتزيد من
ثقتهم بوعده ونصره.
وهذا الأمر تكرر في القرآن الكريم كثيراً لأهميته، كقوله تعالى:
{فَاصْبِرْ
إنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلا
يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لا يُوقِنُونَ}
[الروم:
60].
والتوكل واليقين مستلزمان للصبر والتأني وعدم الاستعجال وعدم الاستجابة للاستفزازات
وعدم الرضوخ لردات الفعل، ولهذا حين أخبر الله تعالى موسى وهارون بإجابة دعوتهما
أمرهما بالاستقامة، والتي تعني في وجه منها «ترك الاستعجال ولزوم السكينة والرضا
والتسليم لما يقضي به الله سبحانه»[8].
ثانياً:
دعاء الله تعالى وسؤاله الثبات والنصر والتمكين، وهو أمر لازم للتوكل على الله
تعالى، فمن توكل على الله حق التوكل لجأ إليه واستنصره وطلبه.
ولذلك سارع المؤمنون من قوم موسى بالدعاء حين أمرهم بالتوكل:
{فَقَالُوا
عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لا
تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِـمِينَ
85
وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ
86}
[يونس:
85، 86].
والدعاء الوارد في هذه الآيات على شقين:
دعاء أهل الدعوة لأنفسهم، كما سبق. ودعاء أهل الدعوة على أعداء الله وأعدائهم، كما
أخبرنا الله تعالى في الآيات:
{وَقَالَ
مُوسَى رَبَّنَا إنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ
وَمَلأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْـحَيَاةِ
الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِكَ
رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ
عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلا يُؤْمِنُوا حَتَّى
يَرَوُا الْعَذَابَ الأَلِيمَ}
[يونس:
٨٨].
أهل الدعوة لا غنى لهم عن اللجوء إلى الله وطلب النصرة منه والتثبيت على دينه
وتمكينهم من أعدائه..
وهذا مقتضى الإيمان والتوكل على الله، وهذا دأب الأنبياء والمرسلين، وسوف يجعل الله
لهم مخرجاً مما هم فيه.
والآيات المتكاثرة تصرح بأنه لا أحد يستطيع أن يتفوق على قدرة الله وإرادته في
إدارة الصراع بين أهل الحق وأهل الباطل:
{إن
يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلا غَالِبَ لَكُمْ
وَإن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي
يَنصُرُكُم مِّنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ
فَلْيَتَوَكَّلِ الْـمُؤْمِنُونَ}
[آل
عمران:
160]،
{وَمَا
النَّصْرُ إلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إنَّ
اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ}
[الأنفال:
10]،
{أَلَمْ
تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ
الْفِيلِ
1
أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ
2}
[الفيل:
١، ٢]،
لذلك فإن الدعاء واحدٌ من أسباب النصر المهمة ورفع الاستضعاف، وطريق نحو التمكين
ودفع البلاء والفتنة، والذين يبتكرون الأساليب والطرق النافعة لإيجاد مخارج من
أزمات الظروف التي يعيشونها، ثم هم يغفلون عن أثر الدعاء؛ إنما يركضون خلف السراب،
لأن هذه الأسباب مهما قويت كلها أضعف من الدعاء.
والدعاء عبادة تنم عن عبودية في القلب لله عز وجل، وإخبات وذل وخضوع له، والذين
يغفلون عن الدعاء إنما يتنكبون باب العبودية مستكبرين، معتمدين على ذكائهم وقوتهم
وأساليبهم لا على الله عز وجل، وهو القائل:
{وَقَالَ
رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إنَّ
الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي
سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ}
[غافر:
60]،
فعن أي تمكين يبحثون وعن أي نصر يطلبون وهم في الحقيقة عن الصراط ناكبون!
ثالثاً:
الإقبال على الصلوات برغم الخوف والاستضعاف، وإقامتها وعدم تركها البتة.
وقد جاء ذلك صريحاً في قوله تعالى:
{وَأَقِيمُوا
الصَّلاةَ}
[يونس:
87]
أي بجميع حدودها وأركانها مستخفين ممن يؤذيكم[9]،
وإشارة في قوله تعالى:
{وَاجْعَلُوا
بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً}
[يونس:
87]
أي اتخذوها مساجد، وصلوا فيها مستخفين في حال خوفكم من فرعون وقومه، فلا تتركوا
الصلاة والإقبال عليها بأي حال.
قال ابن كثير رحمه الله:
«وكأن هذا
-
والله أعلم
-
لما اشتد بهم البلاء من قبل فرعون وقومه، وضيقوا عليهم، أمروا بكثرة الصلاة، كما
قال تعالى:
{يَا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا
بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ}
[البقرة:
٣٥١].
وفي الحديث:
كان رسول الله
صلى الله عليه وسلم
إذا حزبه أمر صلى» أخرجه أبو داود[10].
لا شكَّ أن الحال عسيرة وأن الخطب مدلهم..
والإقبال على الصلوات يرفع العسر ويفرج الهم ويكشف الضوائق.
وقد كان بنو إسرائيل في تلك الحال على درجة من الخوف والاضطراب لا يقدر على تسكينهم
وتثبيتهم إلا الله، فأمرهم الله أن يتخذوا مساجد في دورهم متوجهة نحو القبلة، على
رأي جمع من المفسرين، أو أمرهم أن يصلوا في بيوتهم لئلا يقعوا تحت طائلة التعذيب
والإرهاب، على رأي جمع آخر من المفسرين[11].
وفي الحالتين أمروا بالعناية بالصلاة في هذا الظرف القاتم، لكونها معينة لهم على
الثبات والفلاح، ولكونها القلعة الأخيرة في مقامات الإيمان وأركان الإسلام، فيجب
المحافظة عليها وإلا سقطت مدينة الإيمان في القلوب.
وإذا جاز للمسلمين ترك بعض الشعائر للحال التي يعيشونها في دار الحرب؛ فإن عمود
الدين
-
أعني الصلاة
-
لا ينبغي بحال تركه أو التفريط به.
قال ابن عباس:
كانوا خائفين فأمروا أن يصلوا في بيوتهم.[12]
وقد امتثل نبينا محمد
صلى الله عليه وسلم
وأصحابه لهذا الهدي فكان النبي
صلى الله عليه وسلم
إذا حضرت الصلاة
-
حين كانت الدعوة سراً
-
خرج إلى شعاب مكة، وخرج معه علي بن أبي طالب
t
مستخفياً من أبيه أبي طالب ومن جميع أعمامه وسائر قومه، فيصليان الصلوات فيها، فإذا
أمسيا رجعا[13].
قال ابن إسحاق:
«وكان أصحاب رسول الله
صلى الله عليه وسلم
إذا صلوا ذهبوا في الشعاب، فاستخفوا بصلاتهم من قومهم»[14].
ويتملكك العجب حين تتخيَّل أولئك الثلَّة المؤمنة من الصحابة رضي الله عنهم وقد
حضرتهم الصلاة، وهم في خوف وسرِّية، فيتسللون إلى الشعاب والأودية عبر مجموعات
صغيرة، يتلفتون يمنة ويسرة، فيقوم أحدهم يرقُب الأوضاع من مسافة؛ ليصفَّ الباقون
أقدامهم لله تعالى، خاشعين ذاكرين، ثم يصلي هو نوبته!
إنها مشاهد يخفق لها القلب وترتجف لها الجوارح إجلالاً ومهابة.
قال سعيد بن زيد
t:
«استخفينا بالإسلام سَنَة، ما نصلي إلا في بيتٍ مغلق أو شعب خالٍ، ينظر بعضنا لبعض».
وفي رواية للبلاذري أن النبي
صلى الله عليه وسلم
وأصحابه كانوا إذا جاء وقت العصر تفرقوا في الشعاب فصلوا، فرادى ومثنى، فبينما
رجلان من المسلمين يصليان في إحدى شعاب مكة إذ هجم عليهم رجلان من المشركين كانا
فاحشين فناقشوهما ورموهما بالحجارة ساعة، حتى خرجا فانصرفا[15].
فلمَّا اتخذ النبي
صلى الله عليه وسلم
دارَ الأرقم مقراً لدعوته، أصبحت الصلاة أحد الأعمال المقامة فيها.
هذا الجهد والترقب والتخوف والتسلل والتحري..
كله لأجل إقامة الصلاة التي كتبها الله عليهم فرضاً لازماً.
لقد كانت تلك الصلاة تبني قيمهم وإيمانهم وتُشربهم الفضائل والمعالي:
{اتْلُ
مَا أُوحِيَ إلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ
وَأَقِمِ الصَّلاةَ إنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى
عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْـمُنكَرِ}
[العنكبوت:
45]،
وحين واجهت المسلمين موجةٌ قوية تريد صدَّهم عن هذا الدين الجديد الذي غيَّرهم كانت
التربية على إقامة الصلاة هي ذلك السدَّ المنيع من الانجراف في هذه الموجة:
{كَلَّا
لا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ}
[العلق:
19]،
وحين كان المسلمون مأمورين بالعفو عن أذى قريش وعدم الاصطدام بهم أو الانتقام
منهم
{كُفُّوا
أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ}
[النساء:
٧٧]،
كانت التربية على إقامة الصلاة تسهم بشكل كبير في تخفيف تلك المعاناة والضيم، من
خلال ترشيد انفعالات المسلمين وتسكين نفوسهم وتهدئة ثائرتهم.
لقد كانت إقامة الصلاة ولا تزال تخفف من الضغوطات وتعيد النفس إلى خطها الانفعالي
المعتاد:
{إنَّ
الإنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا
19
إذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا
20
وَإذَا مَسَّهُ الْـخَيْرُ مَنُوعًا
21
إلَّا الْـمُصَلِّينَ
22}
[المعارج:
19
-
٢٢]،
ذلك أن الاستقرار النفسي له تأثيره الإيجابي في رفع مستوى التدين والارتقاء في
سلَّم الإيمان؛ الأمر الذي كانت الصلاة تصنعه في نفوس أهلها.
إن الصلاة
-
باختصار
-
تقوم بالأدوار المهمة التي تقوم بها المحاضن التربوية، وهي التربية الذاتية في زمن
انعدام الجماعية، لذلك أمر الله تعالى بني إسرائيل بالإقبال على الصلاة لتقوم بهذه
الأدوار المهمة.
والآية لا تشير إلى إقامة الصلاة المفروضة فحسب، بل تشير إلى الإكثار من الصلاة في
أزمنة الخوف والاستضعاف، كما أشار إلى ذلك ابن كثير رحمه الله.
التربية الحركية:
لمست في هذه الآيات الكريمات جميل عناية الله بعباده المؤمنين، وكريم عطفه عليهم،
فلم يتركهم يواجهون الشدائد والخطوب دون معونة منه، بل أعانهم ووجههم سبحانه إلى ما
فيه صلاحهم في هذه المرحلة العصيبة.
وهذه عادته سبحانه، يعرفها من تأمل توجيهاته مع الأنبياء الكرام، ويعرفها أولياؤه
الذين بذلوا حياتهم وأرواحهم لدينه.
وهذا مقتضى معية الله لعباده المؤمنين.
الجانب الحركي أحد دعائم الدعوة إلى الله؛ حيث تتفاوت ظروف الدعوة وتتغير المؤثرات
من حولها، مما يستوجب حركة منظمة مدروسة تواكب هذه المتغيرات، وتسهم في تحقيق أهداف
الدعوة، وحمايتها من محنة الأعداء، ولهذا قال ابن كثير في قوله تعالى:
{وَأَوْحَيْنَا
إلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّءَا
لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا}
[يونس:
87]
الآية:
«يذكر تعالى سبب إنجائه بني إسرائيل من فرعون وقومه، وكيفية خلاصه منهم»[16]،
فهذه الأسباب المادية الحركية تقوم بدورها في إسناد الدعوة وحمايتها بإذن الله.
وهي تمثل المكوِّن الثاني في بناء الدعوة إذا اعتبرنا أنَّ التربية الإيمانية هي
المكوِّن الأول.
وفي هذه القصة نلمس عدداً من معالم الحركة في مرحلة الاستضعاف والخوف، وفي زمن
الشدائد والخطوب، وهي:
أولاً:
قيادة واضحة:
يرجع إليها الجميع، بشكل مباشر أو غير مباشر، تكون مهمتها الرئيسية في هذه المرحلة
الحفاظ على وحدة الهدف وصحة المسار.
وهذا يقتضي طريقة منهجية في تعاطي التوجيهات، ربما يعتبرها البعض بدهية لا تحتاج
إلى تنبيه، وهي كذلك في حال الرخاء والتمكين، أمَّا في حال الاستضعاف والخوف
والخطوب فهي بحاجة إلى تنبيه، لِما يصيب العقولَ حينئذٍ من التشتت وفقد التركيز
والحيرة والاضطراب.
الآيات الكريمات تبين موقع نبي الله موسى عليه السلام في هذه الحال، فمنه صدرت
التوجيهات ودار الحوار بينه وبين قومه، وفي آيات أُخر أشار القرآن إلى رجوع القوم
إليه وشكواهم للحال في حضرته:
{وَقَالَ
الْـمَلأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ
مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ
وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ قَالَ سَنُقَتِّلُ
أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإنَّا
فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ
127
قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ
وَاصْبِرُوا إنَّ الأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا
مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ
لِلْمُتَّقِينَ
128
قَالُوا أُوذِينَا مِن قَبْلِ أَن تَأْتِيَنَا
وَمِن بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَى
رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ
وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الأَرْضِ فَيَنظُرَ كَيْفَ
تَعْمَلُونَ
129}
[الأعراف:
127
-
129].
وتشتت المرجعية لدى أهل الدعوة في مرحلة الاستضعاف والشدائد من الأخطاء التي قد
تصيب الدعوة في مقتل، والتفرق والتنازع طريق الفشل:
{وَلا
تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ
وَاصْبِرُوا إنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ}
[الأنفال:
46].
وإن تعدد القيادات عملياً على الميدان مؤذنٌ بالتنازع مؤدٍّ إلى الفشل، وهذا الأمر
بحاجة إلى وصية الله تعالى فيه وهي الصبر على توحيد القيادة وتوحيد الهدف، ولذلك
أردف القرآن الكريم التحذير من التنازع بالأمر بالصبر لكون ذلك شاقاً على النفوس،
فإن النفس يشق عليها أن تنزل عن رأيها وحجتها وجماعتها وحزبها، فجاء القرآن ليأمر
بالصبر على الاجتماع تحت كلمة واحدة وهدف واحد.
وإذا كان فيمن سبق يرجع الناس إلى أنبيائهم، فإنه يتوجب علينا الرجوع إلى ورثة
الأنبياء من العلماء العاملين الذين جمع الله فيهم علم الشريعة والبصيرة بالواقع،
فإنهم الأقدر على التوجيه السديد، والأجدر على تحمل أعباء القيادة، وإنَّ علينا
الرجوع إليهم لاسيما في مدلهمات الأمور ووقت الشدائد والخطوب؛ حتى لا تزل قدم بعد
ثبوتها:
{وَإذَا
جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أَوِ
الْـخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ
إلَى الرَّسُولِ وَإلَى أُوْلِي الأَمْرِ
مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ
مِنْهُمْ وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ
وَرَحْمَتُهُ لاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إلَّا
قَلِيلًا}
[النساء:
83]،
فتأمل هذا التنبيه الرباني؛ قال البغوي رحمه الله في الذين يستنبطونه:
«هم العلماء»[17]،
أمَّا ابن زيد فيرى أنهم قيادات المسلمين في الحرب، والحرب فيها من الشدائد والخطوب
ما هو معلوم، يقول:
«الولاة الذين يكونون في الحرب عليهم، الذين يتفكرون فينظرون لما جاءهم من الخبر
أصدق أم كذب، أباطلٌ فيبطلونه أو حقٌ فيحقونه.
قال:
وهذا في الحرب»[18].
ثانياً:
تنظيم أماكن الإقامة والسكن:
وذلك بحسب الهدف والخطة والاحتياج، قال الله تعالى:
{وَأَوْحَيْنَا
إلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّءَا
لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا}
[يونس:
87]،
قال السعدي رحمه الله:
«حين اشتد الأمر على قومهما من فرعون وقومه، وحرصوا على فتنتهم عن دينهم»[19]،
فأراد الله لهم خطة تكون سبباً في نجاتهم من هذه الفتنة والأذى، فأوحى سبحانه إلى
موسى أن يتخذ لقومه بيوتاً غير بيوتهم التي كانوا يسكنونها، فيستخفوا فيها ويأووا
إليها.
وقد كانوا ساكنين أرض جاسان قرب مدينة منفيس قاعدة المملكة يومئذ في جنوب البلاد
المصرية[20].
والمقصود بقوله تعالى «بمصر» الإسكندرية في قول مجاهد[21]،
وهي كما تعلم في أقصى الشمال.
ولم تكن هذه البيوت فقط بغرض الفرار من فتنة فرعون، بل هي توفر بيئة جيدة للتربية
على الدين، حيث البعد عن مواطن الرقابة الفرعونية المترصدة لأهل الإيمان.
كما توفر جواً صحياً نقياً من ملوِّثات الجاهلية الفرعونية، لأن أهل هذه البيوت في
عزلة مباينة عن فرعون وقومه.
وهي تمثل كذلك بيئة صالحة لتربية الأقربين والذراري على دين الله، وفوائد أُخر من
هذه البيوت.
ثالثاً:
إقامة الصلاة في هذه البيوت:
بعد أن أصبحت صلاتهم في المساجد والكنائس مستحيلة، لمنع فرعون لهم من ذلك وتخريبها،
فتكون هذه البيوت مجمعاً مباركاً لأهل الدعوة يقيمون فيها صلاتهم، ويتدارسون فيها
أحكام دينهم.
قال الله تعالى:
{وَاجْعَلُوا
بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ}
[يونس:
87]،
تماماً كما فعل النبي
صلى الله عليه وسلم
حين اتخذ دار الأرقم بجوار جبل الصفا، اختارها رسول الله
صلى الله عليه وسلم
ليجتمع فيها بالمسلمين سراً، فيتلو عليهم آيات الله ويزكيهم ويعلمهم الكتاب
والحكمة، وليؤدي المسلمون عبادتهم وأعمالهم، ويتلقوا ما أنزل الله على رسوله
صلى الله عليه وسلم
وهم في أمن وسلام؛ وليدخل من يدخل في الإسلام ولا يعلم به الطغاة من أصحاب السطوة
والنقمة[22].
بعض المفسرين ذكر اتجاه البيوت نحو القبلة، وسعيد بن جبير رحمه الله ذكر في معنى
قوله تعالى:
{وَاجْعَلُوا
بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً}
[يونس:
87]:
اجعلوا بيوتكم يقابل بعضها بعضاً[23].
ولعلَّ هذه القيود تناسب أن تكون تفاصيل لخطة النجاة والحماية، والله أعلم.
وفي كل الأحوال أنت ترى ترتيباً وتنظيماً للمواقع والأماكن، وهذه أمور مادية تحتاج
الدعوة إليها بحسب الظروف.
رابعاً:
الاستمرار وعدم التوقف عن الدعوة والتربية:
وإن اختلفت المسارات بحسب الظروف، وهذا الثبات هو مفتاح النصر والظفر والنجاة، فحين
دعا موسى ربه تعالى ربط الله تعالى إجابته لدعائه بالاستمرار والثبات، فقال تعالى:
{قَالَ
قَدْ أُجِيبَت دَّعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا}
[يونس:
89].
والاستقامة في أحد معانيها هي الثبات على طريق الدعوة والاستمرار في تبليغ الرسالة،
قال الفراء وغيره:
أمر بالاستقامة على أمرهما والثبات عليه من دعاء فرعون وقومه إلى الإيمان، إلى أن
يأتيهما تأويل الإجابة[24].
فالتوقف عن الدعوة والتربية أو الضعف بسبب الشدائد والخطوب لا يؤديان إلا إلى
انتكاسة الميدان وهزيمة أمام فرعون وملئه، وهذا ما ينبغي لأهل الدعوة والتربية أن
يحذروه.
خامساً:
الركود وعدم الاستجابة للمؤثرات غير الموضوعية:
كالاستفزازات. ومن ذلك الصبر والتأني وعدم الاستعجال، فإنَّ أكثر ما يعيق تقدم
الحركات الدعوية هو سرعة استجابتها للإثارة التي يصنعها خصومها.
والاستعجال لا يصدر إلا من الجهال[25]
قال الله تعالى:
{وَلا
تَتَّبِعَانِّ سَبِيلَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ}
[يونس:
89]
أي:
لا تسلكان طريق الذين يجهلون حقيقة وعدي، فتستعجلان قضائي، فإن وعدي لا خُلف له،
وإن وعيدي نازلٌ بفرعون، وعذابي واقع به وبقومه[26].
قال الشوكاني:
«والمعنى:
النهي لهما عن سلوكِ طريقةِ منْ لا يعلم بعادة الله سبحانه في إجراء الأمور على ما
تقتضيه المصالح تعجيلاً وتأجيلاً»[27].
وقد يتأخر وعد الله لحكمة يريدها كما تأخر هنا، قال ابن جريج:
«يقولون:
إنَّ فرعون مكث بعد هذه الدعوة أربعين سنة»[28]!
سادساً:
التفاؤل والاستبشار بنصر الله القريب:
{وَبَشِّرِ
الصَّابِرِينَ}
[البقرة:
155]،
قال القرطبي:
«بشر بني إسرائيل بأنَّ الله سيظهرهم على عدوهم»[29]،
وقال السعدي:
«بالنصر والتأييد وإظهار دينهم، فإن مع العسر يسراً، إنَّ مع العسر يسراً.
وحين اشتدَّ الكرب وضاق الأمر؛ فرَّجه الله ووسعه»[30].
لا شك أنَّ ذلك يخالف المنطق المادي، الذي يصوِّر لك المعركة بالحسابات المادية:
العدة والجند والعتاد والواقع، لكن التفاؤل والاستبشار ينبعان من شيء غير مادي،
ينبعان من عقيدةٍ راسخة، ينبعان من اليقين بوعد الله تعالى وكلماته التي قال فيها:
{وَلَقَدْ
سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْـمُرْسَلِينَ
171
إنَّهُمْ لَهُمُ الْـمَنصُورُونَ
172
وَإنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ
173}
[الصافات:
١٧١
-
137]،
ولهذا ربط اليقين بالصبر وعدم الاستعجال وعدم الاستجابة لأفعال الخصوم، فقال سبحانه:
{فَاصْبِرْ
إنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلا
يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لا يُوقِنُونَ}
[الروم:
60]،
قال ابن جرير الطبري:
«فاصبر يا محمد لما ينالك من أذاهم، وبلغهم رسالة ربك، فإن وعد الله الذي وعدك من
النصر عليهم والظفر بهم وتمكينك وتمكين أصحابك وتُبَّاعك في الأرض:
حق»[31].
وقال ابن عاشور:
«الخفة مستعارة لحالة الجزع وظهور آثار الغضب.
ونهي الرسول عن أن يستخفه الذين لا يوقنون نهيٌ عن الخفة التي من شأنها أنْ تحدث
للعاقل إذا رأى عناد من هو يرشده إلى الصلاح، وذلك مما يستفز غضب الحليم،
فالاستخفاف هنا هو أنْ يؤثروا في نفسه ضد الصبر»[32].
في واقع الأمر إنَّ عدداً من المؤشرات المادية يدعو إلى التفاؤل، وإنَّ دراسة واقع
الدعوة ومحيطها بموضوعية يدفع نحو الاستبشار بالنصر؛ لكن الآلة الإعلامية الساحرة
تصوِّر للناس خلاف ذلك.
وهنا تنبيه مهم للغاية؛ فالصبر وعدم الاستعجال، والتفاؤل والاستبشار..
كلها لا تعني أن يكون المسلم جامداً سلبياً لا يتحرك في الدعوة إلى الله تعالى
ينتظر الأقدار، فإن ذلك مخالف للأمر بالاستقامة في الآيات، وهذا القعود السلبي هو
من شأن المتصوفة الذين يرون حرمات الله تنتهك ودينه يمتهن دون أن يكون لهم خطة عمل
تناوئ ذلك، ودون تحرك جاد ولو كان بطيئاً.
والتاريخ مسوَّدٌ بمثل هذه الخطيئة التي وقع فيها من تلوثوا بالتصوف، ومما يؤسف له
ما ذكره المؤرخ الجبرتي في تاريخه يصف مثل هذه الحالة حين غزا الفرنسيون مصر، فيقول:
«وقد كانت العلماء عند توجه مراد بك تجتمع بالأزهر كل يوم، ويقرؤون البخاري وغيره
من الدعوات، وكذلك مشايخ فقراء الأحمدية والرفاعية والبراهمة والقادرية والسعدية
وغيرهم من الطوائف وأرباب الأشاير، ويعملون لهم مجالس بالأزهر، وكذلك أطفال
المكاتب، ويذكرون الاسم اللطيف وغيره من الأسماء»[33]..
أهكذا تكون خطة الدفاع عن أرض الإسلام وحمايتها من الغزاة الصليبيين؟!
أم هكذا تواجه الشدائد والخطوب؟!
الدرس الكبير:
على أية حال..
فإن الأزمان الشديدة على أهل الإيمان والظروف التي تعترضهم في طريق دعوتهم موجبةٌ
لأعمال وأحوال تناسب هذه الظروف والأزمان، وإنَّ على أهل الإيمان أنْ يعلموا أنَّ
عليهم في هذه الظروف واجبات إيمانية وواجبات حركية، يستنبطون معالمها من الوحي
الهادي:
{وَكَأَيِّن
مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ
كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِـمَا أَصَابَهُمْ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا
اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ
146
وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إلَّا أَن قَالُوا
رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإسْرَافَنَا
فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا
عَلَى الْقَومِ الْكَافِرِينَ
147
فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ
ثَوَابِ الآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ
الْـمُحْسِنِينَ
148}
[آل
عمران:
146
-
148].
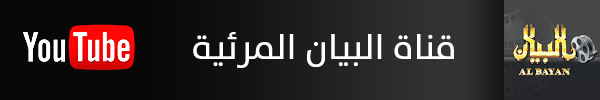
:: مجلة البيان العدد 350 شــوال 1437هـ، يـولـيـو 2016م.
[1] انظر تفسير ابن كثير 4/287.
[2]
انظر تفسير الطبري
7/149،
وتفسير السعدي
2/727
، وقد ناقش هذا القولَ الحافظُ ابنُ كثير، وقال:
في هذا نظر
4/288.
[3]
تفسير التحرير والتنوير
11/260.
[4]
في ظلال القرآن
3/1816.
[5]
في ظلال القرآن
3/1815.
[6]
تفسير الطبري
11/151.
[7]
تفسير القرطبي
8/236.
[8]
فتح القدير
2/598،
وانظر تفسير القرطبي
8/240.
[9]
نظم الدرر
3/474.
[10]
تفسير ابن كثير
4/289.
والحديث عند أبي داود رقم
1319.
[11]
انظر القولين في تفسير الطبري
11/153.
[12]
تفسير الطبري
11/151.
[13]
السيرة النبوية لابن هشام
1/283.
[14]
السيرة النبوية لابن هشام
1/300.
[15]
انظر:
دراسة في السيرة لعماد الدين خليل ص63.
[16]
تفسير ابن كثير
4/289.
[17]
تفسير البغوي
1/567.
[18]
تفسير الطبري
5/183.
[19]
تفسير السعدي
1/728.
[20]
تفسير التحرير والتنوير
11/265.
[21]
تفسير الطبري
11/155.
[22]
الرحيق المختوم ص97.
وللاستزادة عن تاريخ دار الأرقم يراجع الطبقات
3/224
وسير أعلام النبلاء
479.
[23]
انظر تفسير الطبري
11/154-155.
[24]
تفسير القرطبي
8/240.
[25]
مفاتيح الغيب
6/130.
[26]
تفسير الطبري
11/161.
[27]
فتح القدير
2/598.
[28]
تفسير الطبري
11/161.
[29]
تفسير القرطبي
8/238.
[30]
تفسير السعدي
2/728.
[31]
تفسير الطبري
21/58.
[32]
تفسير التحرير والتنوير
21/153.
[33]
عجائب الآثار
2/185.